
2025-04-13 89
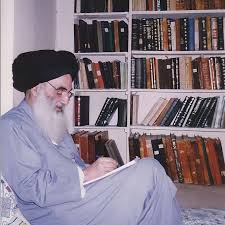
الدولة في الفكر الشيعي بين حضور المعصوم وغيابه
الشيخ معتصم السيد أحمد
الإسلام، في جوهره، ليس مجرد
مجموعة من العقائد أو الطقوس الدينية فحسب، بل هو منهج حياة شامل
يهدف إلى تنظيم كافة جوانب الوجود البشري، بحيث يشمل هذا المنهج
تنظيم العلاقات الاجتماعية، الاقتصادية، والسياسية، بالإضافة إلى
تطوير الأنظمة التي تحقق العدالة والاستقرار للمجتمع. فالإسلام يقدم
إطاراً متكاملاً لإدارة شؤون الأمة، ويعتمد في ذلك على مبادئ عامة
تسمح بالمرونة والمواءمة مع التغيرات الزمانية والمكانية. فهو لا
يفرض نموذجاً سياسياً ثابتاً أو نظاماً محدداً، بل يفتح المجال
لتطوير حلول مرنة تراعي الظروف المختلفة، ومنها غيبة الإمام المهدي
عليه السلام، وهي مرحلة افتقدت فيها الأمة القيادة المباشرة التي
كانت تتولى تنظيم شؤونها الإدارية والسياسية.
ومن أبرز القضايا التي تُطرح في
هذا الإطار، هي مسألة الإمامة في الفكر الشيعي وموقعها في إدارة
الدولة. فالإمامة في الفكر الشيعي ليست مجرد ولاية حكم دنيوي أو
منصب سياسي، بل هي امتداد للرسالة السماوية التي بدأها النبي محمد
صلى الله عليه وآله وسلم، فالإمامة ضمن هذا السياق تمثل القيادة
الروحية والزمنية للأمة الإسلامية، وتعدّ عنصراً أساسياً في
استمرارية التطبيق الصحيح للمبادئ الإسلامية في مختلف جوانب الحياة.
لكن مع غيبة الإمام المهدي عليه السلام، يطرح تساؤل مشروع حول كيفية
استمرارية هذه القيادة في جنبتها السياسية. ومن هنا، تبرز الحاجة
لفهم أوسع لمفهوم الإمامة ودور المرجعية في هذا السياق.
من المؤكد أن الإسلام يوفر للأمة
مبادئ أساسية من قبيل العدل والشورى وحفظ الحقوق وتوزيع السلطة بما
يضمن تحقيق العدالة والاستقرار في المجتمع، فهذه المبادئ تمثل الأطر
التي يجب أن تُوجه بها سياسات الأمة وتُبنى عليها أنظمتها، الأمر
الذي يفتح المجال لتعدد النماذج الإدارية التي تتناسب مع التطورات
السياسية والاجتماعية في كل زمان ومكان. ولهذا، تبرز أهمية أن
يُحدَّد الشكل الأمثل للإدارة السياسية عبر التشاور بين العقلاء
وأهل الخبرة، حيث يتم تطوير الأنظمة السياسية والإدارية بما يتلاءم
مع احتياجات العصر ومتغيراته.
ولا يعني ذلك إهمال دور المرجعية
الدينية، بل تبرز أهميتها بشكل أساسي باعتبارها امتداداً للإمامة
وضمانة لاستمرار تطبيق الأحكام الشرعية وحفظ التدين الصحيح في
المجتمع. إذ تقوم المرجعية بدور حيوي في الإرشاد والتوجيه الفكري
والشرعي، مما يعزز التزام الأمة بالقيم الإسلامية في مختلف جوانب
حياتها. ومع ذلك، يختلف مفهوم دور المرجعية بين من يعتقد بتعميمه
ليشمل القيادة السياسية بشكل كامل، كما في نظرية ولاية الفقيه، وبين
من يرى أن دورها محصور في بيان الأحكام الشرعية وبعض الأمور
المتعلقة بالحسبة والإشراف على الشؤون الدينية والاجتماعية. وهذا
التنوع في النظرية يعكس واقعاً عملياً تتعايش فيه عدة أنماط من
العلاقة بين المرجعية والنظام السياسي، كما نشاهده في بعض الدول ذات
الأغلبية الشيعية.
هذا الاختلاف في الرأي يعكس سعة
الأفق في الاجتهاد الشيعي ويُظهر مرونة الفكر الإسلامي في التكيف مع
الظروف المتغيرة. إذ يفتح هذا التنوع في الاجتهاد المجال أمام
خيارات متعددة، تسمح بتطوير النظام الأمثل الذي يتناسب مع المرحلة
التاريخية التي تمر بها الأمة، ويواكب التطورات السياسية
والاجتماعية، وفي ذات الوقت يلتزم بالقيم الإسلامية العليا التي لا
يمكن المساس بها. وبذلك يصبح هناك نوع من التكامل بين المؤسسة
الدينية وجميع أهل الخبرة والاختصاص في جميع المجالات الاجتماعية
والاقتصادية والسياسية، وهذا النوع من التكامل هو الذي يوفر الفرص
المناسبة لبناء نظم سياسية واجتماعية تجمع بين أصالة الدين وبين
متطلبات العصر.
فالنظام الإسلامي لا يتطلب
بالضرورة أن يكون الحاكم هو رجل دين فقط، بل يمكن أن يتم اختيار
الحكام بناءً على معايير عقلية وواقعية تتعلق بكفاءتهم وقدرتهم على
إدارة شؤون الدولة بما يضمن رفاهية المجتمع واستقراره. فالإسلام
يعترف بوجود تخصصات مختلفة في إدارة الدولة، والفقه الإسلامي يعطي
مساحة كبيرة للخبرات المهنية والعلمية في هذه المجالات، في حين تبقى
القيم الإسلامية هي الموجهة لهذا التخصص.
وعلى سبيل المثال، عندما نناقش
النموذج الإيراني في إدارة الدولة، من المهم ألا يُفسر هذا النموذج
بوصفه مثالاً يُحتذى به في جميع السياقات، أو فرضية قابلة للتكرار
في كل البلدان. فالنموذج الإيراني يتمتع بخصوصية ناتجة من تداخل عدة
عوامل تاريخية واجتماعية وحضارية يصعب توفرها في جميع البلدان، ولذا
لا يمكن نقله حرفياً إلى سياقات أخرى دون مراعاة تلك الخصوصيات.
والمهم في الأمر هنا هو التأكيد على أن الإسلام لا يقدم نموذجاً
جامداً بل يفتح المجال لقاعدة مرنة تتيح للأمة اختيار آليات مناسبة
لإدارة الدولة، تتكيف مع التغيرات الزمانية والمكانية.
ومن هنا يتضح أن المرجعية الدينية
في الإسلام يمكن فهمها على أنها أداة مرنة لا تقتصر على تقليد نموذج
معين، بل تمتد لتشمل معايير ومبادئ توجيهية تسمح بتطوير أشكال
متنوعة من النظم السياسية والإدارية. وبالتالي، الدولة الإسلامية في
عصر غيبة الإمام المهدي عليه السلام ليست محكومة بنمط سياسي محدد،
بل يمكن للأمة أن تختار النماذج التي تتناسب مع ظروفها ومتطلبات
العصر الذي تعيش فيه، بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار في المجتمع
وفقاً للقيم الإسلامية العليا.
وعلى هذا الأساس، يتبين أن الدولة
المدنية الإسلامية في غيبة الإمام المهدي عليه السلام ليست فكرة
بعيدة عن المعتقدات الأساسية في الفكر الشيعي، بل هي امتداد طبيعي
لتطبيق المبادئ التي تضمنتها الشريعة الإسلامية، والتي تفتح المجال
لإنشاء أنظمة سياسية وإدارية مرنة تتناسب مع متغيرات العصر دون أن
تتناقض مع ثقافة الانتظار لظهور الإمام المهدي. فثقافة الانتظار
التي يعيشها المسلمون الشيعة هي ثقافة حيوية، تشجع على الاستمرار في
العمل والبناء على أسس إسلامية، وتحث الأمة على المساهمة الفعالة في
تحسين أوضاعها الاجتماعية والسياسية، بينما تظل عيون المؤمنين
متوجهة نحو مستقبل يشرق فيه الإمام المنتظر ليحقق العدالة
الكاملة.
فالحديث عن الدولة المدنية القائمة
على القيم الإسلامية لا يتعارض مع التوجيهات الإسلامية، بل الإسلام
يطالب المسلمين بضرورة تحقيق العدل ورفع الظلم وتوفير الأمن
والارتقاء بالمجتمعات تنموياً وحضارياً. فالدولة المدنية التي
نقصدها قائمة على مبادئ الشورى، العدالة، الحرية، وحفظ الحقوق،
مضافاً إلى القيم الأخلاقية، وهذه المبادئ يمكن أن تُطبق ضمن نظام
مدني إسلامي يضمن لجميع فئات المجتمع المشاركة في صنع القرار، ويخلق
بيئة من التعاون بين المؤسسات الدينية والمدنية لتوجيه الأمة نحو
أهدافها المشتركة.
وبالنسبة لدور المرجعية الدينية في
هذا السياق، فإنه يستمر في التأكيد على دورها كمرشد فكري وشرعي،
يعزز من استقرار المجتمع وضمان التزامه بالقيم الإسلامية العليا.
وفي الوقت ذاته، فإن المرجعية يمكن أن تمارس دوراً توجيهياً يواكب
احتياجات العصر في مجالات السياسة والاقتصاد، ولكن ذلك لا يعني فرض
نموذج معين أو إلغاء الفوارق بين التخصصات المختلفة. فكما أُشير
سابقاً، يمكن أن تكون المرجعية مرشدة في الأمور الشرعية، بينما
يُمنح المجال لغيرها من المؤسسات التي تضم الخبرات والكفاءات في
المجالات السياسية والإدارية لتسيير شؤون الدولة وفقاً للظروف
الحالية.
وفي المحصلة، فإن جوهر هذا التصور
للدولة المدنية الإسلامية في عصر الغيبة يكمن في خلق نظام مرن يعكس
روح الإسلام، الذي يعترف بضرورة التكيف مع الظروف المتغيرة دون
التفريط في المبادئ. هذه الدولة المدنية ستكون شاهدة على وحدة الأمة
الإسلامية وتعاونها المشترك من أجل بناء مجتمع إسلامي معاصر يعكس
قيم الإسلام العظيمة، ويستعد في نفس الوقت لظهور الإمام المهدي عليه
السلام، الذي سيكمل مسيرة العدالة في الأرض، ويُسهم في تحقيق الرؤية
الإسلامية الكاملة للحكم والتعايش.
الأكثر قراءة
30518
19159
14595
11278


