
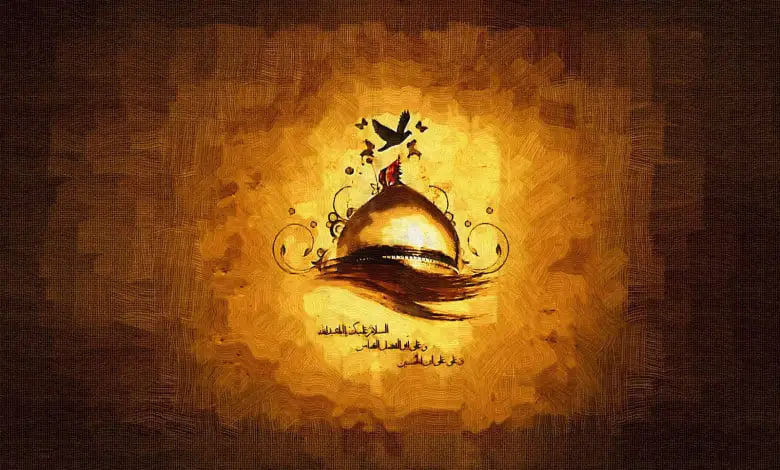
ثورة الإمام الحسين (ع): بين المبادئ الإلهية والظروف التاريخية
الشيخ معتصم السيد أحمد
يعتبر خروج الإمام الحسين بن علي
عليهما السلام في وجه يزيد بن معاوية من أعظم الثورات التي شهدها
التاريخ الإسلامي، ليس فقط من حيث وقعها الصادم في ضمير الأمة، وإنما
من حيث دلالاتها الأخلاقية والدينية والسياسية. وقد كثرت التساؤلات عن
طبيعة هذا الخروج، وهل كان بدافع الاستجابة لرسائل أهل الكوفة، أم أن
الأمر أعمق من ذلك؟ وهل كان الإمام ليستجيب لولا تلك الدعوات؟ وهل
لمعاهدة الصلح بين الإمام الحسن (عليه السلام) ومعاوية دور في تبرير
ثورته؟
للإجابة عن هذه الأسئلة لا بد من
التفريق بين عاملين متكاملين:
الأول: المبدأ الذي انطلقت منه
الثورة الحسينية.
والثاني: الظروف التي ساهمت في إنضاج
هذا المبدأ ودفعه نحو التنفيذ.
إن أحد أبرز أسباب خروج الإمام
الحسين (عليه السلام) يكمن في المسؤولية الشرعية التي فرضها عليه
الانحراف العميق الذي دخل على الحكم الإسلامي مع وصول يزيد إلى
السلطة. فقد كانت خلافة يزيد انحرافاً صارخاً عن مقاصد الشريعة، لما
عُرف به من مجاهرة بالفسق وشرب الخمر وقتل الأبرياء. ومن هنا قال
الإمام الحسين (عليه السلام) مقولته الخالدة: «ويزيد رجل فاسق، شارب
الخمر، قاتل النفس المحرّمة، معلن بالفسق، ومثلي لا يبايع
مثله».
ومن هنا، فإن الثورة الحسينية لا
يمكن أن تُفهم في إطار رد فعلٍ ظرفي أو موقفٍ عاطفي تجاه حدث سياسي
معيّن، بل هي تعبير صادق عن وعي عميق بطبيعة الحكم في الإسلام، ورفض
جذري لتحويل الدين إلى غطاء لسلطة غير شرعية. لقد كان الإمام الحسين
(عليه السلام) يتحرك في ضوء رؤية رسالية شاملة، ترى أن إقامة حكم الله
في الأرض لا يتم عبر الصفقات السياسية أو المهادنات المصلحية، بل عبر
التمسك المطلق بمبدأ الحق، حتى لو كلف ذلك التضحية بالنفس والأهل
والولد. ولهذا، لم يكن يزيد – بما يمثله من نموذج فاسد للحكم – مجرد
شخص سيء، بل كان تجسيداً لانحراف خطير عن المشروع الإسلامي، فكان لابد
من فضحه والمواجهة معه مهما كانت النتائج.
عهد الإمام الحسن ومعاوية.. السياق
السابق للثورة
من المهم التذكير بأن الإمام الحسين
(عليه السلام) لم يخرج على معاوية بن أبي سفيان بعد صلح الإمام الحسن
(عليه السلام)، احتراماً
للاتفاق الذي تم بينهما، رغم
الانحرافات التي بدأ بها معاوية، بدءاً من خرقه شروط الصلح، وانتهاءً
بإعلانه الوصاية بالخلافة لابنه يزيد، وهو ما يمثل نقضاً صارخاً لكل
مبررات الصلح. فالنص في معاهدة الصلح ينص صراحة على أن «الأمر بعد
معاوية للحسن، فإن حدث بالحسن حدث فللحسين»، وليس ليزيد.
وقد كان هذا الصلح في ذاته خطوة
استراتيجية كشفت زيف الادعاءات التي كان معاوية يتستر بها، وأسقطت
ورقة التوت عن بني أمية، حتى تتضح للأمة حقيقتهم من الداخل، فلا يبقى
لأحد عذر أو التباس. فالإمام الحسن (عليه السلام) بصلحه لم يضف شرعية
لبني أمية، بل جرّدهم من آخر غطاء كانوا يلوّحون به، إذ سرعان ما
انقلب معاوية على كل ما التزم به، معلناً بوضوح أن هدفه لم يكن الدين،
بل التسلط.
لكن الإمام الحسين (عليه السلام) مع
ذلك لم يثر، مراعاة للعهد، وانتظر حتى هلك معاوية، وعندها كانت الظروف
مهيأة لإعلان الاعتراض. فأول ما فعله يزيد هو إرسال كتاب إلى واليه في
المدينة الوليد بن عتبة، يأمره فيه بأخذ البيعة من الإمام الحسين
بالقوة، وإلا: «فاضرب عنقه وابعث إليّ برأسه» (تاريخ اليعقوبي 2/215).
وهنا، رفض الإمام الحسين (عليه السلام) البيعة بشكل قاطع، وقال كلمته
الخالدة: «يزيد رجل فاسق، شارب الخمر، قاتل النفس المحرّمة، معلن
بالفسق، ومثلي لا يبايع مثله».
معلناً بذلك موقفاً قاطعاً لا يحتمل
التأويل، ورافضاً أن تكون الخلافة مطيةً للفساد أو مظهراً شكلياً بلا
محتوى إسلامي، ومؤسساً بذلك لمرحلة جديدة من الصراع بين المشروع
الرسالي والمشروع السلطوي.
ومن هنا كان خروج الإمام الحسين
(عليه السلام) من المدينة ضرورة حتمية لا مفرّ منها، فقد شاءت السنن
الإلهية أن تبدأ أولى خطوات الاعتراض على النظام الأموي عند مرقد رسول
الله (صلى الله عليه وآله)، لتكون بداية الثورة متصلة بأصل النبوة
ومرتبطة بجوهر الإسلام، وهو ما يكشف بجلاء عن أصالة المشروع الحسيني،
كونه استمراراً نقياً للإسلام المحمدي الخالص، في مواجهة الانحرافات
التي مزقت صورة الدين وشوّهت وجه الشريعة.
ولأن حامل المشروع الرسالي لا يقبل
المساومة على مبادئه، ولا يتخلى عن مسؤوليته حين تُقيّده ظروف مكانه،
كان لا بد له من أن يغادر بيئته إذا لم تكن مهيّأة لأداء مهمته، وأن
يبحث عن ساحة أخرى تحتضن رسالته، وتمكّنه من الحركة والتأثير. وقد
أشار القرآن الكريم إلى هذه القاعدة في قوله تعالى: ﴿قَالُوا فِيمَ
كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ، قَالُوا
أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا﴾، ومن
هذا المنطلق كانت هجرة الإمام الحسين (عليه السلام) من المدينة إلى
مكة خطوة أولى ضمن مشروع واسع، يهدف إلى الحفاظ على جوهر الإسلام،
وتحقيق التكليف الشرعي القائم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
كما صرّح بنفسه حين قال: «إني لم أخرج أشِراً ولا بطراً ولا مفسداً
ولا ظالماً، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر
بالمعروف وأنهى عن المنكر».
إن هذا المبدأ الرسالي الذي أعلنه
الإمام الحسين (عليه السلام) هو جوهر الثورة ودافعها الأساسي، أما
بقية الظروف، سواء كانت مشجعة أو معاكسة، فهي لا تغيّر من حقيقة
المشروع، ولا تُعدّ أساساً له، وإن كانت جزءاً من أدواته وحواضنه.
ولذلك لم يغفل الإمام عن استخدام الأسباب الطبيعية وتوظيفها في خدمة
ثورته، فاختار مكة المكرمة وجهةً أولى، لأنها الحرم الأول ومهوى أفئدة
المسلمين، ومركز اللقاء العالمي السنوي في موسم الحج، مما يتيح له
هامشاً من الأمان المؤقت بعيداً عن بطش السلطة، كما يمنحه منبراً
فاعلاً لبث ثقافة الرفض، وإيقاظ الضمير الإسلامي الغافل، وتحريك الأمة
تجاه خطر انحراف السلطة الأموية.
وما إن شاع نبأ توجه الإمام الحسين
(عليه السلام) إلى مكة، حتى بدأت تحركات أهل الكوفة تتفاعل. فقد كان
أهل العراق يترقبون فرصة للثورة على بني أمية، وكانوا يبحثون عن قيادة
شرعية ومؤهلة توجّه هذا الغضب الشعبي. فاجتمع زعماؤهم في دار سليمان
بن صُرد الخزاعي، وكتبوا رسالة مطوّلة إلى الإمام الحسين (عليه
السلام) جاء فيها: «قد بلغنا أن ولده اللعين قد تأمّر على هذه الأمة
بلا مشورة ولا إجماع ولا علم من الأخبار، ونحن مقاتلون معك، وباذلون
أنفسنا من دونك، فاقبل إلينا فرحاً مسروراً مأموناً مباركاً، سديداً
وسيداً، أميراً مطاعاً، إماماً خليفة علينا مهدياً...».
ثم لم تمضِ إلا أيام قليلة حتى توالت
الرسائل على الإمام من كل حدب وصوب، حتى بلغ عددها الآلاف، وكلها
تتضمن الدعوة للقدوم إلى الكوفة وقيادة الأمة في مواجهة الظلم. وإزاء
هذا المد الجماهيري، أرسل الإمام الحسين (عليه السلام) ابن عمه مسلم
بن عقيل إلى الكوفة، ليستوثق من جدية الموقف، ويأخذ البيعة بالنيابة
عنه، فقام مسلم بدوره، وأخذ البيعة من الآلاف، وأرسل إلى الإمام رسالة
يستحثّه فيها على القدوم.
وعلى الرغم من أن الظاهر كان يوحي
بانفتاح الأفق أمام الحسين (عليه السلام)، إلا أنه كان على يقين من أن
مصيره شهادة، ومصير أصحابه القتل والسبي، لكنه مع ذلك مضى بعزمٍ لا
يعرف التردد، وخطب في أصحابه عند خروجه من مكة قائلاً: «الحمد لله، ما
شاء الله، ولا قوة إلا بالله، وصلى الله على رسوله، خطّ الموت على ولد
آدم مخطّ القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي، اشتياق
يعقوب إلى يوسف، وخُيّر لي مصرعٌ أنا لاقيه، كأني بأوصالي تُقطّعها
عُسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، فيملأن مني أكراشاً جوفاً
وأجربةً سغباً، لا محيص عن يومٍ خُطّ بالقلم، رضا الله رضانا أهل
البيت، نصبر على بلائه، ويوفّينا أجور الصابرين، لن تشذ عن رسول الله
لحمته، بل هي مجموعة له في حظيرة القدس، تقرّ بهم عينه، ويُنجز بهم
وعده، فمن كان باذلاً فينا مهجته، وموطّناً على لقاء الله نفسه،
فليرحل معنا، فإني راحلٌ مصبحاً إن شاء الله». (بحار الأنوار، ج 44، ص
366).
إن هذه الكلمات تكشف بوضوح عن عمق
وعي الإمام الحسين (عليه السلام) بالمآل الذي ينتظره، ومدى استعداده
الكامل لتحمّل التبعات، بل استعداده لأن يُقدّم جسده فداءً للمبدأ،
وروحه قرباناً لإحياء الدين، ودمه مشعلاً يُنير للأمة طريق الخلاص.
لقد خرج الحسين (عليه السلام) لا لينجو بنفسه، بل ليوقظ الأمة، ويفتح
في وجدانها جرحاً لا يندمل، يبقى حيّاً ما بقي الإسلام.
وفي الختام: كانت ثورة الإمام الحسين
(عليه السلام) ثورة وعي ومسؤولية، لا ثورة غضب ولا رغبة في سلطة. وهي،
في عمقها، دعوة مستمرة لكل جيل لإعادة النظر في علاقته بالسلطة
والعدالة والدين. فإن ثورة كربلاء لم تكن حادثة عابرة في التاريخ، بل
كانت تجلياً عملياً لصراع الحق مع الباطل، وموقفاً خالداً في وجه
الفساد والانحراف.
والذين يحصرون الثورة في بعدها
السياسي أو في رسائل أهل الكوفة يظلمون عمق المشروع الحسيني، الذي جسد
الإسلام المحمدي الأصيل في أبهى صوره، وسجل بدمه الشريف الفصل الأخير
في معركة بدأت منذ زمن، لكنها لم تنتهِ، وستبقى حية ما دام هناك ظلم
في الأرض، وما دامت هناك أمة تستلهم من الحسين (عليه السلام) صرختها
في وجه الطغاة: «هيهات منا الذلة».


